الكرة في ملعب منظمة التحرير الفلسطينية
بقلم
نقولا ناصر / كاتب عربي من فلسطين المحتلة
 إن
"الطريق المسدود" الذي يقف دون إحراز أي تقدم في المفاوضات التي أطلقتها عملية "أنابوليس"
والعدوان على قطاع غزة الذي تهدد دولة الاحتلال "الاسرائيلي" بتصعيده إلى محرقة
نازية "هولوكوست، كما قال نائب وزير الحرب "الاسرائيلي" "ماتان فلنائي" يوم
الأربعاء الماضي، وحد تحويل القطاع إلى "أرض محروقة"، كما قالت اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانها يوم الأحد، هما سببان كافيان تماما لكي تبادر
قيادة المنظمة إلى ما هو أكثر من التضامن اللفظي والإدانة الشكلية لكي توقف
المفاوضات لا أن "تعلقها" لبضعة أيام فحسب كما فعلت، ولكي تفرج عن الاعتقال السياسي
للرأي الآخر في الضفة الغربية، وتوقف تعاملها مع القطاع ككيان معاد بحاجة إلى
"تحرير"، وتوقف التنسيق الأمني الموجه أساسا ضد (حماس)، لتوفر بذلك عمليا أرضية
مواتية ذات مصداقية لاستئناف الحوار الوطني على أساس اتفاقي "القاهرة ومكة" و"وثيقة
الأسرى" لاستشراف برنامج وطني أجهض عدم الاتفاق عليه وسوف يجهض كل المبادرات
للمصالحة الوطنية.
إن
"الطريق المسدود" الذي يقف دون إحراز أي تقدم في المفاوضات التي أطلقتها عملية "أنابوليس"
والعدوان على قطاع غزة الذي تهدد دولة الاحتلال "الاسرائيلي" بتصعيده إلى محرقة
نازية "هولوكوست، كما قال نائب وزير الحرب "الاسرائيلي" "ماتان فلنائي" يوم
الأربعاء الماضي، وحد تحويل القطاع إلى "أرض محروقة"، كما قالت اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانها يوم الأحد، هما سببان كافيان تماما لكي تبادر
قيادة المنظمة إلى ما هو أكثر من التضامن اللفظي والإدانة الشكلية لكي توقف
المفاوضات لا أن "تعلقها" لبضعة أيام فحسب كما فعلت، ولكي تفرج عن الاعتقال السياسي
للرأي الآخر في الضفة الغربية، وتوقف تعاملها مع القطاع ككيان معاد بحاجة إلى
"تحرير"، وتوقف التنسيق الأمني الموجه أساسا ضد (حماس)، لتوفر بذلك عمليا أرضية
مواتية ذات مصداقية لاستئناف الحوار الوطني على أساس اتفاقي "القاهرة ومكة" و"وثيقة
الأسرى" لاستشراف برنامج وطني أجهض عدم الاتفاق عليه وسوف يجهض كل المبادرات
للمصالحة الوطنية.
فعندما يشهد قادة
منظمة التحرير الفلسطينية على رؤوس الأشهاد بأن طريق المفاوضات التي التزموا بها
لتحقيق "المشروع الوطني" قد وصلت إلى طريق مسدود فإن اعترافهم العلني بفشل نهجهم
السياسي لن يكون مجديا إذا لم يقرنوا هذه المقدمة بالنتيجة المنطقية لها لكي يعلنوا
وقف هذه المفاوضات والعودة فورا ودون أية شروط إلى الوحدة الوطنية بالوقف الفوري
أولاً وقبل كل شيء آخر لعملية الاعتقال السياسي الجماعي للرأي الآخر التي قادت إلى
الانقسام الوطني الدموي الراهن المنبثق عنها.
لقد تتالت مؤخرا
الشهادات العلنية لـ"قادة أوسلو" بفشل نهجهم التفاوضي حد اليأس للتلويح علنا أيضا
بخيارات أخرى لم تستبعد "الكفاح المسلح، في مراحل قادمة" كما قال في الأردن الأسبوع
الماضي الرئيس محمود عباس مهندس أوسلو والموقع على الاتفاق الأم له في واشنطن عام
1993، ولم تستبعد كذلك إعلان الاستقلال من جانب واحد دون مفاوضات كما قال الأمين
العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، مما يرمي بكرة المصالحة
الوطنية في ملعب منظمة التحرير التي إذا لم يحفزها الدم الوطني المسفوح ضد الاحتلال
في قطاع غزة للمبادرة إلى الخطوة الأولى فلا شيء يمكن أن يحفزها بعد ذلك لتغليب
الوحدة الوطنية على احتكار الرأي الواحد لصنع القرار الوطني.
لقد جاءت "الشهادة
القنبلة" التي قالت في النهج التفاوضي لـ"أهل أوسلو" ما لم يقله فيها أشد معارضيها
"تطرفا" في المقابلة الهامة مع ياسر عبد ربه التي نشرتها صحيفة "هآرتس"
"الاسرائيلية" يوم الخميس الماضي وهو مفاوض مخضرم من نشط أعضاء "فريق مفاوضات الوضع
النهائي" الذي يرأسه احمد قريع، مفاوض يكاد أن يصبح التفاوض حرفة له وكان "بلدوزرا"
لكل "مبادرات السلام الفلسطينية" مرورا بـ"مبادرة جنيف" وانتهاء بـ"خطة أنابوليس"
التي تجري في إطارها وعلى أساسها المفاوضات الراهنة التي وصفها عفيف صافية، أحد
أبرز الدبلوماسيين الفلسطينيين، في بيان استقالته كسفير لمنظمة التحرير في واشنطن،
وصفاً كاريكاتيريا ساخراً بأنها "مفاوضات على مفاوضات ما قبل المفاوضات"، حتى أصبح
من العناوين الأبرز لـ"عملية السلام" الجارية منذ عام 1991 التي لم تفته جولة واحدة
من جولاتها وبالتالي أصبح عنواناً لنجاحها كما لفشلها.
إذ يبدو أن كيل الخداع
"الاسرائيلي" قد طفح حد أن يفقد حتى هذا المفاوض المخضرم قدرته على احتمال المزيد
منه فالمفاوضات الدورية منذ أيار/مايو الماضي بين عباس ورئيس وزراء "دولة" الاحتلال
"ايهود اولمرت" تحولت إلى عملية "خداع كبيرة" كما نسبت "هآرتس" إلى عبد ربه وصفها،
بينما ينظر الشارع الفلسطيني إلى فكرة حل الدولتين باعتبارها "نكتة" بعد أن فقد
"إيمانه في احتمال تحقيق أي شيء من الحوار مع "اسرائيل" ولن يطول الوقت قبل أن لا
يجد هو أيضا (أي عبد ربه)، أي خيار آخر سوى الانضمام إلى هذا الشارع للاستنتاج
بأنه لا بد من إيجاد طريقة جديدة لإنهاء الاحتلال، لأن المحادثات مع "اسرائيل" قد
وصلت إلى طريق مسدود".
وفي معرض تعليقه على
رفض الرئيس عباس وقريع وصائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في المنظمة، لاقتراحه
إعلان الاستقلال من جانب واحد دون مفاوضات قال عن عريقات ما يقوله المعارضون لأوسلو
في مفاوضي أوسلو جميعهم: "لي أصدقاء غارقون في حب ابدي للمفاوضات ، لان المفاوضات
أصبحت جوهر حياتهم ، (أصبحت) مهنة (لهم)" ، قبل أن يصف اقتراحه نفسه بأنه كان "صدى
لليأس الفلسطيني".
وحول تقويمه للنتائج
التي تمخض عنها "مؤتمر أنابوليس" وما يتوقعه لعملية "أنابوليس" اتفق عبد ربه مع
معارضي "أنابوليس" الذين تصدر هو نفسه الحملة على معارضتهم: إن "الواقع على الأرض..
يظهر أن الأمور قد أصبحت أسوأ كثيرا بعد "أنابوليس" فالبناء في المستوطنات لم يتوقف
وعدد الحواجز ازداد. لقد حشرنا أنفسنا في زاوية رسمناها لأنفسنا بالإعلان أنه في
نهاية عام 2008 سوف يكون هناك عالم جديد وحياة مختلفة هنا، إنني لا أعتقد بأن أي
شيء هام سوف يحدث في العملية بنهاية العام".
وفي التفاصيل سخر عبد
ربه من اتفاق محمود عباس و"اولمرت" على إنشاء ثمانية لجان للشؤون المدنية بينما ما
يزالان مختلفان على القضايا الجوهرية باعتباره "نكتة": "لا بأس من الحديث عن نوعية
البيئة وعن العلاقات الاقتصادية لكن ما أريد أن أعرفه هو ما هي السلطة الفلسطينية
التي ستقيم علاقات اقتصادية مع "اسرائيل" وهل ستكون دولة كانتونات، إنهم الآن
يبحثون إدارة المعابر الحدودية قبل أن يناقشوا الحدود! وأريد أن أعرف أين ستكون تلك
المعابر، بين الضفة الغربية وبين "اسرائيل" أم بين وادي غور الأردن وبين المملكة
الأردنية الهاشمية"!!.
و"يشك" عبد ربه بأن
"الهدف من المفاوضات هو خلق انطباع لدى العالم الخارجي بأن الأمور تتحرك وأن الهدف
هو أن يكون في الإمكان القول للأميركيين عند كل زيارة لكوندوليزا رايس (وزيرة
الخارجية الأميركية المقرر وصولها إلى "اسرائيل" اليوم) أو عند زيارة (الرئيس جورج
دبليو. بوش) في أيار / مايو أننا قد فعلنا شيئا فهم (الأميركان) سوف يسرهم معرفة أن
ثمانية لجان قد أنشئت"، دون أن يشير المسؤول الفلسطيني لا من قريب ولا من بعيد إلى
أن زيارة بوش المقبلة متزامنة مع احتفالات "اسرائيل" بالذكرى السنوية الستين
لاستقلالها التي تصادف الذكرى السنوية الستين للنكبة الفلسطينية.!!
"وفي نهاية المطاف"،
كما قال عبد ربه الذي يرأس "تحالف السلام الفلسطيني"، "يفترض بالمرء أن يصوغ ثقافة
سلام بينما لا يوجد حتى الآن أي أساس للسلام، إن هذا عبث، إنه خداع للنفس، لأننا
نتجنب القضايا الأساسية: القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات.. وإذا لم نعالج هذه
المسائل الأساسية قبل نهاية عام 2008 لا بد لنا من إعلان الفشل وذلك سوف يقود إلى
أزمة لن تكون اقل حدة من تلك التي أعقبت كامب ديفيد"، في إشارة إلى انتفاضة الأقصى
التي انفجرت أواخر تشرين الأول / أكتوبر عام ألفين والتي تحاول "عملية أنابوليس"
تصفيتها وتصفية آثارها بالتصفية الجسدية لقوى المقاومة التي أفرزتها خصوصا في قطاع
غزة حيث حوصرت.
ولفت النظر أن عبد ربه
حمل مسؤولية الخداع كاملة لـ"اسرائيل" وتحاشى أي إشارة أو نقد إلى مسؤولية واشنطن
عن وضع المفاوضات التي استؤنفت بضغط منها وبرعايتها وتمويلها والتي أعلن وصولها إلى
طريق مسدود، لكنه اظهر اطلاعا مباشرا على نبض الشارع عندما قال أن الفلسطينيين
"الآن فقدوا كل إيمان لهم في كل شيء وفي كل شخص له علاقة بالمفاوضات مع "اسرائيل""،
مما يفسر شهادته الجريئة لكنه لا يفسر لماذا لا ينسجم هو وفريقه التفاوضي الذي يقود
المنظمة مع هذا النبض الشعبي.
لكن القارئ لهذه
الشهادة إذا كان يسجل لعبد ربه جرأته الأدبية في إعلان حقائق تدين النهج الذي تبناه
وقيادة المنظمة طويلا فأنه يلاحظ غياب أي نقد ذاتي لديه لهذا النهج ولدور أصحابه في
إيصال الوضع الفلسطيني إلى ما هو عليه الآن وفي الوقت نفسه لا يسجل له جرأة مماثلة
في استخلاص النتائج المنطقية وإعلان مواقف سياسية تتفق مع المقدمات التي أعلنها في
شهادته، التي بعثت رسالة هامة إلى المجتمع الدولي تنذره بانفجار خطير لكنها بدت
رسالة مبتورة قاصرة عن بعث رسالة إلى المجتمع الوطني تبشره بانفراج في أزمة
الانقسام الوطني المستحكمة.
لقد لامس عبد ربه
النقد الذاتي لكنه استنكف عنه صراحة: "والنتيجة هي أن الناس حتى في الضفة الغربية
يقولون: لأن الناس في غزة عارضوا "اسرائيل" بالصواريخ فأنهم أرغموا "الاسرائيليين"
على الانسحاب.. وصدقني إنني لا أستطيع أن أجادل ضد ذلك، ولا يسعني إلا أن أبذل جهدا
كبيرا عندما أحاول أن أثبت لأحدهم بأن هذه المقولة خطأ، ثم هناك مثال جنوب لبنان...
" في إشارة إلى نجاح المقاومة اللبنانية في إرغام قوات الاحتلال "الاسرائيلي" على
الانسحاب دون شروط عام ألفين.
اعتقال الرأي الآخر
لقد سلطت وفاة الشيخ
مجد البرغوثي أثناء التحقيق معه وهو في عهدة أجهزة امن السلطة الفلسطينية في رام
الله ضوءا ساطعا على عملية الاعتقال السياسي الجماعي للرأي الآخر الجارية منذ عام
1993 والتي حولت منذ حزيران / يونيو الماضي قطاع غزة إلى أكبر سجن للرأي الآخر في
العالم وحولت الضفة الغربية إلى ساحة كبرى لمطاردة ساخنة له.
والرأي الآخر يتمثل
حاليا بالرأي المعارض لأوسلو واستراتيجيتها واتفاقياتها وما تمخض عنها من احتكار
رأي واحد لصنع القرار الوطني ولإصرار قيادتها على التمسك بها وبنتائجها وبالوضع
الراهن المنبثق عنها، الذي حول "عملية السلام" من طريق مفترض إلى التحرير إلى هدف
في حد ذاته وحول مفاوضي السلام إلى مجرد متحدثين محترفين عنه، بالرغم من دفن أوسلو
تحت جنازير دبابات الاحتلال التي سحقتها مع حكمها الذاتي في ربيع عام 2002.
وهذه المرة (حماس) هي
عنوان الرأي الآخر لكنها ليست كل الرأي الآخر، إذ لم يمض وقت طويل على أول انتخابات
تشريعية ورئاسية عام 1996 لكي تنسى الذاكرة الوطنية أنها كانت أشبه باستفتاءات
أنظمة الحزب الواحد الشمولية ذات لون واحد ومرشح واحد (عمليا إن لم يكن حرفيا)
وأنها جرت وسط مقاطعة شاملة لها من معظم الألوان الأخرى، وجرت على سبيل المثال على
خلفية اعتقال السلطة لأحمد سعادات أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين آنذاك،
قبل أن تعقبها مباشرة الحملة المشهورة في تلك السنة على (حماس)، وبمثل مواصفاتها
جرت الانتخابات الرئاسية عام 2005، وعندما أفسحت انتخابات عام 2006 المجال للنصر
الانتخابي الساحق الذي حققه الرأي الآخر سرعان ما تم الانقلاب السياسي عليه ونشأ
تحالف فلسطيني أميركي مع الاحتلال، لعدم تمكينه من ممارسة "الحكم الذاتي" ناهيك عن
صنع القرار الوطني، وهي العملية المتواصلة حتى الآن والتي قاد فشلها إلى حالة
الانقسام الوطني الراهنة.
في التاسع من شباط
الماضي نشرت "رويترز" تقريراً جاء فيه أن مسؤولين أمنيين أميركان وفلسطينيين وضعوا
خطة للأمن الفلسطيني لدعم السلطة الفلسطينية بإنشاء قوة من خمسين ألفاً من "الجندرمة"
لها هدفان الأول القيام بمهام الشرطة بين المدنيين والثاني كبح "المتطرفين" الذين
يحاولون منع أي "اتفاق للسلام مع "اسرائيل" في المستقبل"، وإذا أضيف لهذين الهدفين
أن التصدي لقوات الاحتلال "ليس" من مهام قوى الأمن الفلسطيني كما أوضح "وزير
الداخلية" في حكومة سلام فياض، عبد الرزاق اليحيي، أثناء زيارة له في نابلس، يصبح
الإطار الاستراتيجي لعقيدة الأمن "الوطني" واضحا تماما.
وهذه استراتيجية يوجد
ثلاث جنرالات أميركان كبار، هم "جيمس جونز" و"وليم فريزر" و"كيث دايتون"، لضمان
الالتزام الفلسطيني بها وقد اعتمدت في "مؤتمر أنابوليس" قبل ثلاثة أشهر "خريطة
الطريق" مرجعية وحيدة لها وهي خريطة أنشأ المؤتمر لجنة ثلاثية أميركية – فلسطينية –
"اسرائيلية" لمراقبة تنفيذ المرحلة الأولى منها التي تتكون من التزام فلسطيني يجري
تطبيقه من جانب واحد بـ"تفكيك البنية التحتية للإرهاب"، وهو استحقاق تلتزم السلطة
حرفيا بتنفيذه ويلتزم الجنرالات الأميركان بالتأكد من التزامها بتنفيذه، والتزام "اسرائيلي"
في المقابل بـ"تجميد" الاستيطان اليهودي الذي يتسارع ويتوسع بدل أن يتجمد، خصوصا في
القدس، دون أن يحرك المراقبون العسكريون الأميركيون الكبار ساكنا للتأكد من
الالتزام "الاسرائيلي".
إن هؤلاء الجنرالات
المفروزين من قيادة الاحتلال الأميركي للعراق لا يمكن أن يكونوا الممثلين المناسبين
لإنهاء أي احتلال أجنبي لأي بلد آخر ناهيك عن إنهاء احتلال حليفهم الاستراتيجي
لفلسطين، وأنها لمفارقة مثيرة للسخرية أن يكون أمثال هؤلاء الممثلين لقيادة كتبت
سجلها في مجال حقوق الإنسان في معسكر اعتقال غوانتنامو الكوبي وسجن أبو غريب
العراقي، هم الأدوات المؤتمنة على بناء دولة فلسطينية "ديموقراطية" يسودها حكم
القانون والنظام خصوصا بعد أن اشترط رئيسهم جورج دبليو. بوش "ديموقراطيتها" شرطا
مسبقا للوفاء بوعده بإقامتها!!!.
ضمن هذا الإطار تجري
منذ أعلنت رام الله حالة الطوارئ في حزيران الماضي عملية اعتقال سياسي جماعي للرأي
الآخر، على الشبهة كإجراء احترازي وقائي، أولاً بحجة منع تكرار ما حدث في قطاع غزة
في الضفة الغربية، وثانيا بحجة منع "المتطرفين" من ارتكاب "أعمال إرهابية" لتعطيل
المفاوضات التي أطلقتها "أنابوليس" من جهة ولمنعهم من تفجير "اتفاق سلام" موعود
أميركيا ومأمول فلسطينيا، لكن "عمليته" فقط مطلوبة "اسرائيليا"، مع أنه ما يزال
سرابا وإن لم يعد يخدع أي طرف من أطرافه، من جهة أرى ، كما تثبت شهادة عبد ربه.
وكان لهذا الإطار
"سابقة" إثبات نتائجه العكسية عندما لجأت سلطة الحكم الذاتي عام 1996 - 1997،
بتأثير ضغوط "شركاء السلام" الأميركيين و"الاسرائيليين" التي لم تستطع مقاومتها،
لمثل ما لجأت إليه منذ ثمانية أشهر من إقصاء الرأي الآخر لـ(حماس) بشن حملة ضدها لا
تختلف كثيرا عما يحدث الآن، وكانت الذريعة هي الحجة ذاتها التي تتذرع السلطة بها
حالياً، أي التقاطع مع الاستحقاقات الدولية والتعلق بوهم الوعود الأميركية ومنع
"اليمين" من الوصول إلى الحكم في دولة الاحتلال، والنتيجة أن التضحية بالوحدة
الوطنية كانت مجانية ولم تخدم سوى أعداءها، وكانت نتائج الانتخابات التشريعية عام
2006 هي الدليل الأحدث على النتائج العكسية لاستراتيجية إقصاء الرأي الآخر.
وإذا كان هذا الإطار
الاستراتيجي لسياسة الاعتقال السياسي للرأي الآخر يحمل سلطة الحكم الذاتي مسؤولية
"البادئ اظلم" فأن الموقف "الدفاعي" الناجم عن ذلك لحركة المقاومة الإسلامية
والمواجهة البطولية الدامية التي يتصدي القطاع المحاصر بقيادتها لعدوان الاحتلال
المتصاعد عليه لا يسوغان أي مسار مماثل لـ(حماس) أو باسمها، خصوصا بعد أن أصبحت
الحركة بحكم الأمر الواقع هي عمليا سلطة الحكم الذاتي في القطاع وبعد أن انتهت
الحقبة الانتقالية للفراغ القانوني والمؤسساتي خلال الفترة التي أعقبت الحسم
العسكري لحالة الانفلات الأمني قبل ثمانية أشهر.
[email protected]

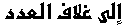
 إن
"الطريق المسدود" الذي يقف دون إحراز أي تقدم في المفاوضات التي أطلقتها عملية "أنابوليس"
والعدوان على قطاع غزة الذي تهدد دولة الاحتلال "الاسرائيلي" بتصعيده إلى محرقة
نازية "هولوكوست، كما قال نائب وزير الحرب "الاسرائيلي" "ماتان فلنائي" يوم
الأربعاء الماضي، وحد تحويل القطاع إلى "أرض محروقة"، كما قالت اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانها يوم الأحد، هما سببان كافيان تماما لكي تبادر
قيادة المنظمة إلى ما هو أكثر من التضامن اللفظي والإدانة الشكلية لكي توقف
المفاوضات لا أن "تعلقها" لبضعة أيام فحسب كما فعلت، ولكي تفرج عن الاعتقال السياسي
للرأي الآخر في الضفة الغربية، وتوقف تعاملها مع القطاع ككيان معاد بحاجة إلى
"تحرير"، وتوقف التنسيق الأمني الموجه أساسا ضد (حماس)، لتوفر بذلك عمليا أرضية
مواتية ذات مصداقية لاستئناف الحوار الوطني على أساس اتفاقي "القاهرة ومكة" و"وثيقة
الأسرى" لاستشراف برنامج وطني أجهض عدم الاتفاق عليه وسوف يجهض كل المبادرات
للمصالحة الوطنية.
إن
"الطريق المسدود" الذي يقف دون إحراز أي تقدم في المفاوضات التي أطلقتها عملية "أنابوليس"
والعدوان على قطاع غزة الذي تهدد دولة الاحتلال "الاسرائيلي" بتصعيده إلى محرقة
نازية "هولوكوست، كما قال نائب وزير الحرب "الاسرائيلي" "ماتان فلنائي" يوم
الأربعاء الماضي، وحد تحويل القطاع إلى "أرض محروقة"، كما قالت اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانها يوم الأحد، هما سببان كافيان تماما لكي تبادر
قيادة المنظمة إلى ما هو أكثر من التضامن اللفظي والإدانة الشكلية لكي توقف
المفاوضات لا أن "تعلقها" لبضعة أيام فحسب كما فعلت، ولكي تفرج عن الاعتقال السياسي
للرأي الآخر في الضفة الغربية، وتوقف تعاملها مع القطاع ككيان معاد بحاجة إلى
"تحرير"، وتوقف التنسيق الأمني الموجه أساسا ضد (حماس)، لتوفر بذلك عمليا أرضية
مواتية ذات مصداقية لاستئناف الحوار الوطني على أساس اتفاقي "القاهرة ومكة" و"وثيقة
الأسرى" لاستشراف برنامج وطني أجهض عدم الاتفاق عليه وسوف يجهض كل المبادرات
للمصالحة الوطنية.